النظام الأبوي وطقوسه المتجذرة في التاريخ
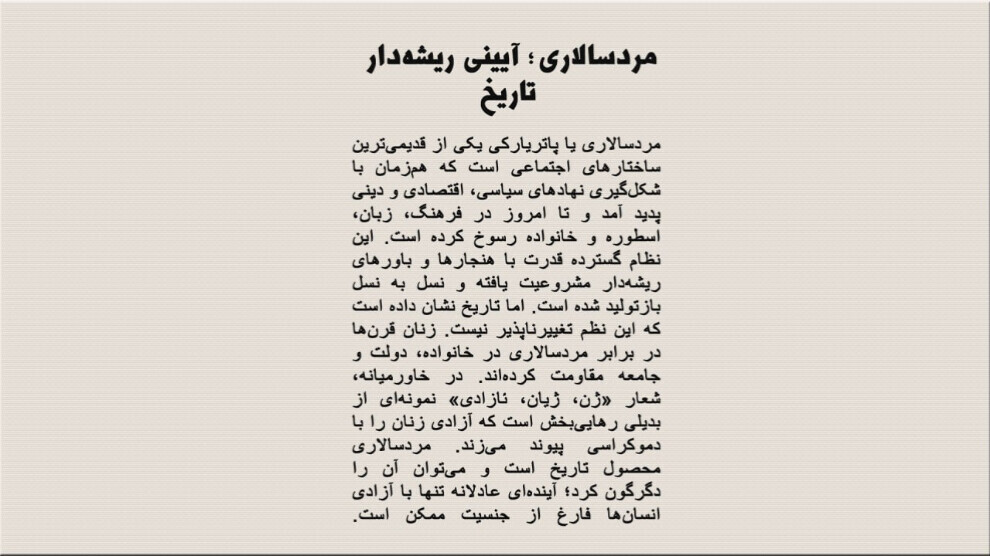
ماريا كريمي
النظام الأبوي هو أحد أكثر الهياكل الاجتماعية والثقافية ديمومة في تاريخ البشرية، وهو هيكل نسج نفسه إلى جانب تشكيل المؤسسات السياسية والاقتصادية والدينية الأولى، في نسيج الحياة الجماعية واستمر بأشكال مختلفة حتى يومنا هذا، عندما نتحدث عن النظام الأبوي، فإننا لا نشير فقط إلى العلاقات بين الرجال والنساء في الأسرة، ولكن أيضاً إلى نظام واسع من السلطة أثر على جميع طبقات الحياة، من العلاقات الأسرية إلى هياكل الدولة وحتى اللغة والأسطورة والفكر، لقد عملت الأبوية كـ "طقوس" أي كنظام من المعنى والقيمة وتم إضفاء الشرعية عليه ليس فقط على أساس القوة، ولكن أيضاً على أساس المعايير والمعتقدات والتقاليد الراسخة، يتطلب فهم هذه الظاهرة العودة إلى أعماق التاريخ، وفحص كيفية تشكيلها، وكذلك الانتباه إلى العمليات التي ضمنت استمراريتها وإعادة إنتاجها .
تُظهر الدراسات الأثرية والأنثروبولوجية أن المرأة في العديد من المجتمعات البدائية كانت لها مكانة محورية، فقد كانت تجمع الطعام، وتصنع الأدوات البدائية، وتحافظ على التقاليد الاجتماعية، وقد تحدث بعض العلماء عن وجود مجتمعات "أمومية" أو على الأقل "متمحورة حول الأم"، حيث كانت الإلهة الأنثوية ودور المرأة كمصدر للحياة محورياً، وتضم الأساطير السومرية والعيلامية والمصرية والهندية آلهةً ترمز إلى الخصوبة والأرض والحب والحياة.
لكن مع الانتقال إلى عصر الزراعة الواسعة والملكية الخاصة، تغير ميزان القوى وأصبحت الأرض تحت سيطرة الرجال كرأس مال رئيسي وازداد التقسيم الجنسي للعمل، أصبحت القوة البدنية للرجال مهمة في الأعمال الشاقة كالزراعة والحرب ونتيجة لذلك تعززت مكانتهم الاجتماعية، تراجعت الإلهات الإناث تدريجياً ليحل محلهن آلهة ذكور، وتحولت أساطير الخلق في العديد من الثقافات لتجعل الرجال حكاماً والنساء رعايا، في نصوص الأساطير الرافدينية، توجد روايات عن آلهة ذكور تسيطر على الإلهات الإناث وتغتصبهن، ويتجلى هذا الاتجاه نفسه في اليونان القديمة، حيث حل زيوس محل إلهة الأرض والخصوبة القديمة كإله الأب.
ولعبت الأديان التاريخية والمؤسسات الدينية دوراً حاسماً في استمرار الطقوس الأبوية، ورغم أن بعض التقاليد تُظهر علامات احترام للمرأة، إلا أن النظام الديني بأكمله اتجه نحو ترسيخ الهيمنة الذكورية، ففي النصوص اليهودية تُصوَّر المرأة على أنها أول المذنبين الذين يُضلّون الرجال أيضاً وفي المسيحية في العصور الوسطى، صُوِّرت المرأة على أنها مُغوية وعاجزة عقلياً، وكان وجودها في المؤسسات الدينية محدوداً أما في الإسلام، فرغم وجود أمثلة على احترام مكانة المرأة، إلا أن التفسيرات التاريخية والفقهية غالباً ما عملت لصالح سلطة الرجل، وحدّت من حقوق المرأة في الطلاق والحضانة والميراث والشهادة.
إلى جانب الدين تحمل الثقافة واللغة أيضاً النظام الأبوي وتُعيد إنتاجه، تحتوي العديد من اللغات على مفردات وتعابير تُصنّف الرجال وتُصنّف النساء "كغيرهن" أو "تابعات" كما تُصوّر الأمثال والأدب الشعبي النساء في أدوار مثل الزوجة الخاضعة المطيعة، أو الأم المُخلصة، مما يُضيّق مجال استقلاليتهن الفردية، وهكذا ترسخ النظام الأبوي ليس فقط في المؤسسات الرسمية، بل أيضاً في اللاوعي الثقافي للمجتمعات.
الاقتصاد والسياسة هما المجالان الرئيسيان لتطور النظام الأبوي واستمراره، مع ظهور الملكية الخاصة ونشأة الدول في بداياتها، تجاوز النظام الأبوي مستوى الأسرة وأصبح ركيزة أساسية من ركائز النظام الاجتماعي، في الأسرة الأبوية كان الرجل رب الأسرة وكانت الزوجة والأبناء تحت سلطته، وقد استُنسخ هذا النموذج لاحقاً في هيكل الدولة، فأطلق الملوك والأباطرة على أنفسهم لقب "آباء الأمة"، وكان الرعايا ملزمين بطاعتهم كأبناء.
وفي الاقتصاد أيضاً، نشأ تقسيمٌ للعمل قائمٌ على أساس الجنس، لعب الرجال دوراً في الإنتاج والتجارة والحرب، بينما اقتصرت النساء إلى حدٍّ كبير على العمل المنزلي والإنجاب، لم يقتصر هذا الفصل على حرمان النساء من الموارد الاقتصادية، بل منح الرجال أيضاً سلطة التحكم في العمل والثروة، في النظم القانونية غالباً ما كانت النساء تابعاتٍ، ولم يكن بإمكانهن اتخاذ قراراتٍ مستقلة دون إذن الرجال.
ومن أهم سمات النظام الأبوي قدرته على إعادة إنتاج نفسه، حتى مع تغير أشكال السلطة الخارجية، يبقى جوهر النظام الأبوي قائماً، فعلى سبيل المثال لعبت المرأة دوراً فعالاً في العديد من الثورات وحركات التحرير، ولكن بعد تأسيس النظام الجديد عادت للتهميش، وفي العصر الحديث ورغم التقدم المحرز في تعليم المرأة وتوظيفها، لا تزال الفجوة بين الجنسين قائمة، ومن أمثلة هذا الاستمرار انخفاض الأجور، ومحدودية فرص الوصول إلى المناصب الإدارية، والصور النمطية الجنسانية في وسائل الإعلام.
تبقى مؤسسة الأسرة إحدى الركائز الأساسية لإعادة إنتاج النظام الأبوي، فالنماذج التربوية التي تُعوّد الفتيات على الطاعة، والفتيان على الهيمنة تُعيد بناء العقليات الأبوية منذ الطفولة، كما تُعزز وسائل الإعلام والسينما والإعلانات هذه الدورة من خلال تصوير المرأة كأداة جمالية أو استهلاكية.
ومع ذلك فإن التاريخ ليس تاريخ هيمنة الذكور فحسب، بل هو أيضاً تاريخ مقاومة النساء وحركاتهن من أجل العدالة، منذ القرن التاسع عشر وحتى الآن تحدّت الحركات النسوية في الغرب والشرق النظام الأبوي بجدية وركزت الموجة الأولى من النسوية على حقوق المرأة في التصويت والتعليم وحقوق الملكية، انتقدت الموجة الثانية في القرن العشرين البنى الثقافية والجنسانية، وشددت على الحريات الجنسية والحق في الإجهاض ومكافحة الصور النمطية الجندرية، تناولت الموجتان الثالثة والرابعة من النسوية تقاطع الجندر مع العرق والطبقة والهويات الأخرى وقدمت رؤية متعددة الجوانب للتمييز.
في العالم غير الغربي، لعبت النساء أيضاً أدواراً مهمة في الحركات الثورية والمناهضة للاستعمار، وفي الوقت نفسه ناضلن من أجل حقوقهن، في الشرق الأوسط تُعدّ نضالات النساء الكرديات مثالاً بارزاً على محاولة ربط التحرر الوطني بتحرر النوع الاجتماعي، لقد تحدّين النظام الأبوي ليس فقط على مستوى الأسرة، بل أيضاً على مستوى الدولة والمستوى الثقافي، واقترحن بديلاً يُسمى "الجنس، الحياة، الحرية" يربط السياسة بتحرر المرأة.
النظام الأبوي ليس نظاماً طبيعياً أو ثابتاً، بل هو نتاج ظروف تاريخية واقتصادية وثقافية راسخة في الطقوس على مدى آلاف السنين، ويعاد إنتاجه من خلال مزيج من القوة والمؤسسات القانونية والاقتصادية، والأهم من ذلك المعايير والقيم الثقافية، ولكن كما يُظهر التاريخ لا يوجد هيكل أبدي وقد أثبتت الحركات الليبرالية والنسوية أنه يمكن تحدي هذا النظام وبناء بدائل مساواتية.
اليوم لم يعد نقد النظام الأبوي مسألةً تتعلق بالجندر فحسب، بل أصبح أيضاً مسألةً جوهريةً تتعلق بالعدالة والحرية والديمقراطية، فما دام نصف المجتمع يعيش في ظل نظام قائم على التمييز فلا سبيل للحديث عن الحرية والمساواة الحقيقيتين، إن إدراك الجذور التاريخية والطقوسية للنظام الأبوي هو الخطوة الأولى لتغييره، هذا الإدراك يقودنا إلى حقيقة مفادها أن البشر كما خلقوا هذا النظام لديهم القدرة على تغييره، إن مستقبلاً خالياً من النظام الأبوي هو مستقبلٌ يُمكّن البشر، بغض النظر عن جنسهم، من تطوير مواهبهم وقدراتهم بحرية.
